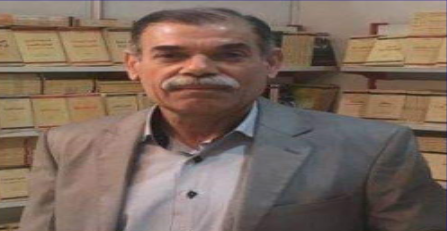
ثامر عباس
لا يظن كل من كتب مقالة في جريدة، أو شارك في حوار متلفز، أو حظي بعضوية حزب سياسي، أو تمتع بحظوة تنظيم ديني، أو تقلد منصب حكومي رفيع، أو حاز على شهادة جامعية، أنه بات محسوبا على رهط المثقفين، وانه أضحى بذلك ينتمي لعالمهم الاعتباري الخاص.
ذلك لأن المعايير والشروط المؤسسة التي يتحدد بموجبها استحقاق الفوز بهذا اللقب، قد لا تنطبق على كل أو بعض ممن أتينا على إيراد ذكرهم، من منطلق أن الثقافة هي بالأساس جديلة أو سبيكة من المكابدات الوطنية والأخلاقية والمعرفية والحضارية والإنسانية، التي من دون حيازتها جميعا لا يحق لأحد ادعاء تمثيلها والزعم بحمل رسالتها والتنطع للتحدث باسمها.
ولعل هذا الأمر يفسّر لنا ليس فقط قلة/ شح وجود مثقفين حقيقيين يحتلون الواجهات الأمامية للساحة الثقافية العراقية ويشيعون خطاباتهم العقلانية في رحابها فحسب، وإنما يعكس تراجع مؤشرات حضورهم السياسي وتدني مستويات تأثيرهم الاجتماعي كذلك.
وبضوء ذلك قد يتساءل البعض؛ إذا كانت تلك المعايير والشروط هي ما تميّز المثقف عن سائر أقرانه من أعضاء المجتمع (الفاعلين الاجتماعيين)، فلماذا إذن يعاني – وهو المتسلح بكل تلك العدة النوعية – غياب الدور وتعطل الوظيفة وانعدام التأثير، في الوقت الذي ينخرط وينشط أشباه المثقفين ومدعي الثقافة على أكثر من صعيد وفي أكثر من جبهة؟!.
في الواقع لو تمعنا جيدا في هذا الأمر لأدركنا أن هذه الحالة/ الوضعية لا يمكن أن تكون إلا على هذا النحو الشائه والمنحرف، طالما أن المجتمع الذي ينتمون اليه ويحملون وشم هويته يعاني لوثة الاستقطاب الأصولي بين جماعاته والاحتراب السياسي بين مكوناته، على أسس من الانتماءات التحتية والولاءات الفرعية، لا سيما أن الخاصية الجوهرية لخطاب المثقف هي ما يجعله عابرا لتلك الانتماءات ومتخطيا لتلك الولاءات.
وعلى هذا الأساس يبدو أن خطاب المثقف العراقي الحقيقي عالق بين شقي رحى؛ (مؤسسات) قائمة على مظاهر الفساد والفوضى، حيث النهب والسلب والتخريب من جهة، و(جماعات)، لا تزال ممهورة بدمغة القبيلة والطائفة والعرق والمنطقة.
الأمر الذي يحول دون أن يكون له صدى في أروقة (دولة)، فقدت شرعيتها الوطنية وتخلت عن سلطتها السيادية من جانب، وكيان مجتمع أضاع وحدة مشتركاته الوطنية والتاريخية والانسانية من جانب ثان. وهنا يبدو خطاب المثقف وكأنه يغرد خارج أسراب الحشود ويعوم ضد التيارات السائدة!، للحدّ الذي يجعل دوره الاجتماعي نافلا ووظيفته التنويرية بلا معنى.
وإذا كان الحال – كما يبدو – سيبقى على ما هو عليه على المدى المنظور في الأقل؛ فهل يبقى هناك أمل بالخروج من هذا الخانق التاريخي المعقد، والخلاص من هذا المأزق الحضاري المستعصي، خصوصا أن كل المعطيات والمؤشرات توحي بان لا جديد يلوح في أفق الثقافة العراقية، التي لا تفتأ مظاهر الجهل والعدمية تكبل عناصرها الحية وتعطل قدراتها الفاعلة؟.
ففي كل الأحوال، ليس هناك من خيار آخر أمام الفاعل الثقافي (المثقف) الحقيقي يمكنه التعويل عليه، سوى الرهان على مكتسبات الحفر العميق في طمى الوعي الراكدة للجماعات المستقطبة، والتنقيب بين أخاديد الذاكرة المجيشة للمكونات المتعصبة.
حيث يستطيع الكشف عن خرافات أصولها المختلقة، وإماطة اللثام عن أساطير تاريخها الملفقة، على أمل حمل الكيانات والمكونات والجماعات المتكارهة والمتصارعة، لاعادة النظر في أساطير تاريخها وخرافات سردياتها التي كانت – وستكون السبب وراء كل مآسي هذا البلد المستباح ومعاناة أفراده وجماعاته المكبلين بأصفاد العبودية السياسية والأمية الثقافية والايديولوجية الدينية.





