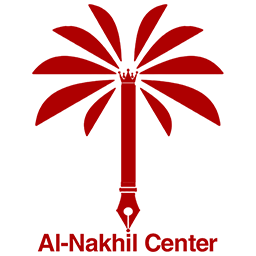رعد أطياف
ليس كل من تكلم عن الحرية وذم القطيع يُرفع له لواء التفرّد، بل قد يكون أنانياً فحسب، ويعاني من مشكلات اجتماعية أبرزها ضعف القدرة للتواصل مع الآخرين، ولا تكشف لنا عن إمكانية فكرية متفرّدة على الإطلاق، ولا عن تحرر فكري ملحوظ. قد تٌختَزَل الحرية لدى معظمنا بإباحية رخيصة وتحلل من كل مسؤولية أخلاقية تجاه الذات والآخرين، وقد تعني فقط حرية تعبير وإطلاق أحكام جزافية، وليست حرية تفكير نساهم فيها بتشكيل العالم.
إذا كنّا ننشد الحرية ببعدها الإباحي، وننشد الحرية بنسختها المشوهة والباهتة بوصفها حرية تعبير فقط وإطلاق أحكام، في حين تبدو حرية التفكير مُعَطَّلَة، ليس هذا فحسب بل تثير ضغينتنا ضد كل من يفكر، فهل يحق لنا ترديد محفوظة القطيع؟ يصح ذلك في عالمنا النرجسي الخاوي، وأعني به بالضبط عالمنا الرقمي الذي أتاح لنا مدونات شخصية تحرك فينا دافع الاشتهاء لنلتهم الأشياء دون أن نمضغها جيداً، والأفق الذي نهتدي به دوماً هو الشعبوية: الغرائز والأهواء العنيفة.
ونغدو هنا أمام ثنائية محيّرة: قطيع يذم القطيع.
ثمة فرضية تعززها الوقائع المعاشة، هي أن كثيرا من المرددين لمفهوم القطيع لا يتمتعون بميّزة ذهنية تؤهلهم لذم القطيع.
وبفضل الواقع الافتراضي أمكننا المضي باطمئنان بهذه الفرضية، نظراً لما يقدمّه لنا هذا الواقع من عيّنات تتمتع بمساحة واسعة للتعبير عن أحكامها المتسرعة، طالما لا تحظى باهتمام جمهور القرّاء الفعليين، ولا تشكل موضوعاً للاكتراث من قبل المهتمين بالشأن الثقافي.
لكن تكمن خطورتها من حيث كونها تحجب الحقائق الفعلية، وتغرقها بتصورات مزيفة تفصلها عن واقعها الحقيقي، وتضخم ذات هي أصلاً خالية من أي ثمرة معرفية، وتسهم في تغذية الأهواء النفسية العنيفة، وتسقط أي مشروع سياسي، لأنها تبداً بالصراخ، وتذم المثقف، ثم تتلاشى وتتنصل عن موقفها بوصفها جماعات منتفضة ضد الفساد السياسي، ويتبيّن لاحقاً ثمّة نسخة من قطيع تذم قطيعاً آخر! لكنّه ذمّ يدور في صورة بالغة التجريد ومحاكاة رديئة ومخجلة.
من المرجّح أن الاستمرار بهذا الذم يعكس رغبة مكبوتة لمحاكاة المثقف بنسخته الأكثر ابتذالاً وتشوهاً، كما أنها انتقام رمزي من كل هؤلاء الذين جعلونا مغمورين.
وبدافع التعويض المفرط نتجه صوب المفاهيم الأكثر بريقاً، والتي تعوض ما فقدناه، أو، بتعبير أدق، تغطي على حرية التفكير التي نشعر بالضغينة تجاهها.
ولكي نكون في حلٍ من المساءلة النقدية، نرمي تلك الأحكام في مدوناتنا الشخصية، بوصفها مدونات لا تقتضي منّا إحالات مرجعية، ولا يطلب منّا الآخرون موقفاً أخلاقياً واضحاً تجاه ما يجري.
بما أن الشعبوية هي السمة الغالبة على المشهد السياسي والثقافي، فلهذه الأصوات جمهور غفير يظهر بشكل موسمي، ثم يغيب كلياً لفقدانه المطاولة، كما ذكرنا، ولرغبته العميقة في خوض المعارك السياسية والاجتماعية بمعزل عن أي نخبة مثقفة.
لقد لا حظنا في حراك تشرين عدوانية مكبوتة تجاه المثقف، حتى أن هذا الأخير استثمر هذا السلوك لتبرير تنصله عمّا حدث في حينها، بيد أن التعميم لوثة فكرية ينبغي عليا استحضار الاستثناء لكي لا نغرق في دوامة الأحكام الجزافية.
صحيح أن هذه النخبة المزعومة تكاد تكون مشلولة وغائبة عن الأحداث السياسية، لكن ذم النخب، وترديد محفوظة القطيع لم يحدث لهذا السبب! بل من المحتمل أنه محكوم بأهواء نفسية عنيفة، أحدى أسبابها الغياب شبه الكلي للنخب المثقفة وخوفها من المد الشعبوي العارم(هذا من باب حسن الظن) من جهة، وطغيان العالم الرقمي بحيث أصبح فضاءً ملائماً للترويج عن نشاطات المثقفين.
أياً ما يكن الأمر، لا يمكن وضع الاثنين في سلّة واحدة، أعني المد الشعبوي الذي يحلو له أن يترجم ضغائنه بذم القطيع! والمثقف السلبي، فهذا الأخير له نقّاده الحقيقيون الذين لا تحركهم الضغائن.