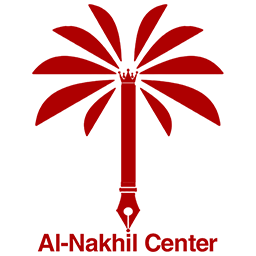نوا زافاليتا
صحفي وكاتب مكسيكي
ترجمة: بهاء الدين السيوف
“في الطريق إلى أن تصبح صحفيا، كل الأشياء ذات أهمية، لكن أهم الأشياء هو أن تكتب كما أمر الله، والله يأمر أن تكون قارئا بالأساس، وأن تقرأ المزيد باستمرار”.
ميغيل أنخيل باستانيير
حين كنا نغادر قاعات الدراسة الجامعية كي نقتحم سوق العمل، ومنذ كنا مبتدئين في عالم الصحافة، كان ذلك يكلفنا الوقوع في كثير من الأخطاء الفادحة، التي بمرور السنوات وتراكم الخبرات، دفعتنا إلى التفكير في كمية الحماقات التي ارتكبناها لدى ولوجنا هذه المهنة الأفضل في العالم كما يسميها غابرييل غارثيا ماركيز؛ مهنة الصحافة.
في أيامنا الأولى بهذه المهنة، حين كنا نريد أن نقضم العالم كله في لقمة واحدة، ثم نتحدث عن المأدبة، كان يتملّكنا تصور خاطئ تماما، حين كنا نظن أن القراء تهمّهم آراؤنا الشخصية في الأحداث الجارية. كان ذلك التصور خطيئة كبرى، مثلها مثل النهم والغطرسة والجشع، ذلك أن قارئ الصحيفة أو المجلة، أو متابع إحدى وكالات الأنباء، يهمه بالدرجة الأولى ما نعرفه عن تلك الوقائع، يشغله ما يمكننا جمعها بأدواتنا الصحفية من حقائق ومعلومات حول اغتيال أحد السياسيين، عن سقوط برج ما، عن انهيار مبنى بفعل هزة أرضية أو عن غرق عبارة في البحر، وعن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب رقم عشرة في أحد أهم أندية الكرة قبيل مباراة مصيرية بدوري الأبطال الأوروبية.
لكن من سابع المستحيلات أن يضغط القارئ زرا ليفتح رابط خبر، أو أن يقلب أوراق الصحيفة، أو أن يتوقف على صفحات مجلة، كي يقرأ ما كتبه شخص لا يعرفه، حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، مبديا آراءه في أي من الأحداث التي أتينا على ذكرها قبل قليل.
عليك أن تتجنب في نصوصك عبارات من قبيل “كصحفي أظن أن…”. إن القارئ يريد الخبر، بالوثائق والتأكيدات، يريد سياقا يناقش رأيه الخاص فيه، ستكون لديه فيما بعد أحكامه التي يبديها أمام دائرة من أصدقائه المقربين، أو ربما مع عابر مجهول في إحدى الحانات أو المقاهي، أو قد يناقش ذلك في ساعة الغداء مع عائلته.
يقدّر القارئ القصص الصحفية التي تأخذ الطابع السردي، والوصف الدقيق والمتزن للشخصيات المختلفة والسيناريوهات المتعددة. ذاك الفيلم الذي يضم 24 رسالة وصورة في الثانية، يُترجَم بألف كلمة ليروي لك وقائع اليوم أو مجريات الأسبوع كله، يصف دقيقة بدقيقة المجرى التفصيلي لحادثة تصادم بين قطارين في دولة أوروبية، يروي بإسهاب تفاصيل المباراة النهائية في الملاكمة، جولة بجولة حتى الكشف عن هوية بطل العالم الجديد، يتتبع مراسم تنصيب الملك أو رئيس الدولة الجديد في بلد عربي، ويحكي أحداث الصراع العسكري الجديد في الشرق الأوسط والأضرار الجانبية التي تلقاها كل من الأطراف المتنازعة.
معضلة أخرى تتبدّى حين يتحدث الصحفي في نصوصه عن الطرق الملتوية والمتشابكة التي قطعها للوصول إلى الصحراء كي يروي قصته، عن ألف إجراء وإجراء أتمّها كي يحصل على تصريح صحفي يخوّله دخول قاعة الإعلاميين لتغطية نهائي كرة القدم، عن الساعات القليلة التي أتيح له النوم خلالها، قبل أن يهرع صباحا إلى التغطية والتحقيق في انفجار قنبلة على إثر صراع ما هنا أو هناك.
الصحفيون الجيدون لا يفعلون ذلك، احترموا أنفسكم واحترموا قرّاءكم، لقد ملّت الجماهير هذه القصص الدرامية وأحاديث معاناتكم الشخصية، ورغبة الصحفي في تحقيق الشهرة واقتحام دور البطولة وجذب المشاهدين. دعوا ذلك للسياسيين ونجوم التلفزيون، اتركوا هذه الطريقة الساذجة “لليوتوبرز” والمؤثرين، الذين يلزمون هواتفهم النقالة بينما هم يسقطون من على لوح للتزلج، أو يتحدّون الحيوانات البرية، أو يُدخلون أشياء غريبة في فتحات أنوفهم لجذب انتباه مشاهدي شبكات التواصل الاجتماعي.
اعتاد الكاتب والمؤرخ الأرجنتيني مارتين كابارُّوس أن يعترف في حواراته، بأنه في كثير من الأحيان يجد نفسه مضطرا إلى ترك قراءة بعض القصص الممتعة والمنشورة في وسائل إعلام عالمية، نتيجة الملل. يقول إن العدل أن تترك قراءة النص حين يضع الكاتب نفسه في واجهة الحكاية، حين يشرع في التغطية على كل زوايا الحدث مُضفِيا عليها سيرته الشخصية.
أحد العوائق، يشبه إلى حد كبير ما يحدث في السينما، حين تصل إلى لحظة الذروة في مسار أحداث الفيلم، وبينما الجميع مشدود إلى الشاشة، يقف رجل سمين في الصف الأول وبيده علبة من الفشار، ويبدأ بمخاطبة ابنه -الذي يجلس إلى جانبه- بصوت أقرب إلى الصراخ، مبديا إعجابه الشديد بالفيلم. كثير من الضجيج سيشتعل حينها، لكن كثيرا من الصحفيين المبتدئين يقعون في فخ الإغواء بأن يذكروا أنفسهم ويُقحموها في القصة بشكل أو بآخر.
واحدة من الحماقات الكبيرة التي يدرج على اقترافها الصحفي المبتدئ أو المتغطرس، أو كلاهما، هي إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، واستعمالها لتفجير قصة صحفية. ينسى الصحفي كثيرا أنه يتقاضى أجره من الصحيفة أو المجلة أو القناة التي يعمل بها، وليس من الفيسبوك ولا من تويتر أو إنستغرام. يسقط الصحفي كثيرا في شرك الأسبقية وفورية النشر اللتين توفرهما شبكات التواصل كي ينبئ العالم بأنه أول من عرف بمجريات حادثة ما، وبالطبع ينشر المضمون الأساسي لقصته في الفيسبوك مصحوبا بصورتين رديئتين، أو يضع سلسلة تغريدات على تويتر، ينتهي بها المطاف إلى أن تطغى على نصِّه الصحفي نفسه.
إن نصا صحفيا كهذا، حين يصل إلى غرفة الأخبار بعد أن يكون قد مرّ على المحرر، وعلى يدٍ خلّاقة تخرجه بصورة مناسبة إلى الفضاء الرقمي، تكون قد لوّثته قبل ساعات أو قبل أيام يد كاتبه الأصلي، الذي باع الخبر بأبخس الأثمان على الفيسبوك، مقابل كمية من الإعجابات والمشاركات ستجعل قصته في آخر الأمر غير مثيرة لأي اهتمام، على الأقل في دائرة الصحفيين والأكاديميين والمبدعين.
أما عن أكبر غطرسات الصحفيين، خاصة حين نكون مبتدئين في هذا المجال، فهي أننا لا نجيد الاستماع، نرخي آذانا صماء أمام إجابات بسيطة لكنها مدروسة تأتي من لسان من هم مصدرنا في المعلومات، يشغلنا أن نبدي لهم أننا نعرف كل شيء، نفهم في السياسة والعلوم والسلام والحرب والرياضة والدين والإنترنت والجنس والفلسفة ومناهج البحث وغير ذلك.
ننسى كثيرا أن وظيفتنا هي أن نخرج إلى الشارع للبحث عن إجابات، وليست وظيفتنا أن نقدم تلك الأجوبة. صحيح أن مهنتنا تُجْبرنا على حيازة مستوى متقدم من المعرفة، لكن ذلك لأنفسنا فقط، لا لكي نفرك به أوجه الأشخاص الذين نقابلهم.
هكذا هو الأمر تماما، حين تُجْري حوارا أو مقابلة مع شخصية مهمة، أو مع أحد السياسيين، أو مع فنان تلفزيوني معروف أو لاعب كرة قدم. ينبغي أن لا يشعر مَن تحاوره أنه يُضيع من وقته عشرا أو عشرين دقيقة لأجلك، يجب أن يحس بأنه في مقابلة ذكية وممتعة، مقابلة مثيرة للجدل وربما ساخنة، علينا أن نتنبّه ببرود شديد إلى وقت المقابلة كيف يمضي، أن نخلق توازنا تاما بين الأسئلة القصيرة والدقيقة والأسئلة ذات الطابع الصحفي، علينا أن نعطيه حيزا كافيا يُظهر فيه ردة فعله ويبدي إجاباته الكاملة، لا أن نجابهه بهيروغليفية لغوية تعتمد السؤال وردة الفعل دائما، ما يجعل تلك الشخصية إما في موقف الدفاع وإما في موقف الإحجام عن الإجابة.
دائما ما يقولها ميغيل أنخيل باستانيير، نائب المدير السابق لصحيفة إلباييس الإسبانية: “إن على الصحفي أن يدغدغ مشاعر ضيفه”، بمعنى أن عليه التحضير والإعداد مسبقا، بدراسة تلك الشخصية التي سيقابلها، أن يجري تحليلا معززا بالاطلاع على مقالات أخرى حول هذا الشخص في وسائل الإعلام المختلفة، بتوثيق هذه المعلومات، ما الأسئلة التي لم تُوجّه إليه بعد؟ ما الجانب الذي لم يُقْتَحم من حياته العامة والخاصة حتى الآن؟ ومن هذا الشخص بعد كل هذا؟ وأيّ المواضِع تستهويه وتجلب تعاطفه؟ كل ذلك حتى يتدفق الحديث الصحفي كما يتدفق النهر.
في الآونة الأخيرة، نجد ملايين النتائج البحثية التي ينشرها مئات الباحثين على الإنترنت، والتي جعلت وصولنا إلى المعلومات التي تهمنا أكثر مرونة وسهولة. قال لي مرة الصحفي الكولومبي خافيير داريّو روستريبو: “لو أن أمك قالت لك إنها تحبك، تحقق من ذلك، تأكّد”. مرت عشر سنوات وما زالت جملته تقتات من رأسي، دائما ما أجدني أوّظف مقولته حين تصلني معلومات أو أرقام لا أجدها منطقية، كاستثمار حكومي أو خاص بمبلغ غير معقول، تأكيد على لسان مسؤول حكومي يثير الشك، يجب التحقق من الأكاذيب، خاصة تلك التي يجزم الكثيرون أنها حقائق مطلقة.
وأخيرا، وهذا مهم جدا، كيف نبدأ كتابة القصة الصحفية؟ لقد حصرت المؤسسات الصحفية التقليدية في أمريكا الشمالية كتاباتنا في إطار ضيق وممل للغاية، حين نلتزم بتراتبية (الفاعل والفعل والمضمون)، أو بالخماسية الأكاديمية المبتذلة والمعروفة (مَن وماذا ومتى وأين ولماذا)، لكن الصحافة السردية دائما ما تصل إلى ما هو أبعد من ذلك، ينبغي أن نجذب قراءنا بشذرات سردية مفعمة بالإيحاءات، وبغمزات لغوية خلّاقة.
افتتح نصك بعبارة استفزازية على لسان الشخصية التي قابلتها، ابدأ بجملة لم تنشرها أي مؤسسة إعلامية حتى الآن، ارسم سيناريو لم يألفه الجمهور قط، اجعل القارئ يجزم منذ الفقرة الأولى أنه سيجد في نصك رواية لم يجدها في سواه من النصوص، وكما قال غارثيا ماركيز: “إن أجود الأنباء هي التي تُرْوَى بالطريقة المُثلى، وليست تلك التي تروى أولا”، أما ما تبقى فتفاصيل صغيرة في المهمة، وليست بأقل أهمية لما يتطلبه عمل المصور والمصمم من دراية، أما نحن، الذين نروي الوقائع والأحداث، فعلينا في كل مرة أن نضع عصارة جهدنا كله في ذلك.
نقلا عن معهد الجزيرة للاعلام